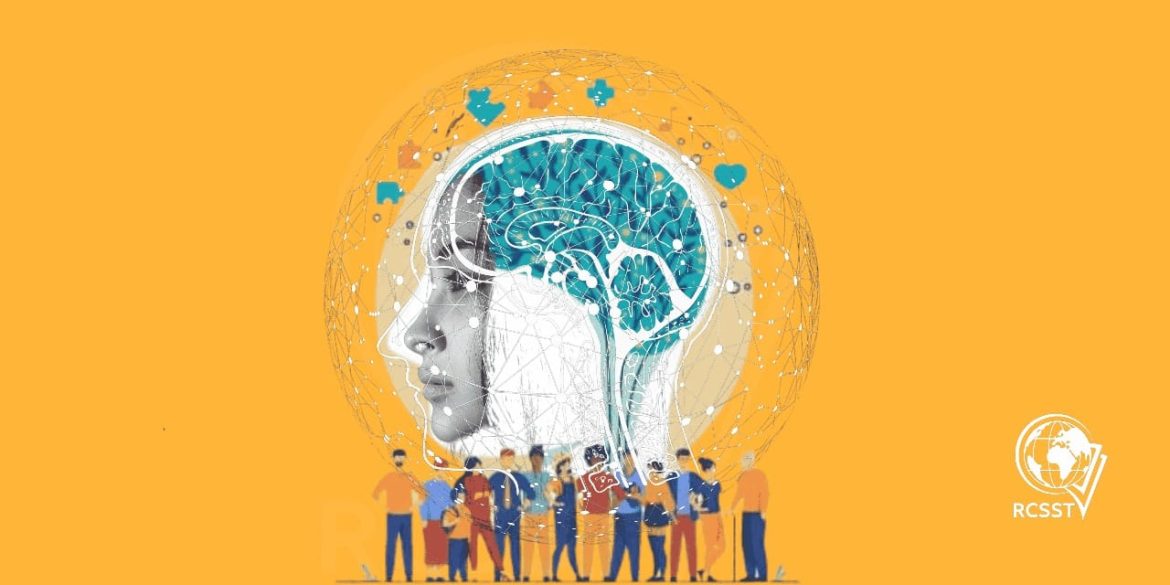الوعي الجمعي
الكاتب:
وذلك لأسباب عديدة، منها:
1. إرباك الوعي:
لا شك أن الوعي الجمعي المصري تعرض، على مدى العقود الماضية، لإرباك منظم أفضى إلى تدهور المنظومة القيمية بالمجتمع والنيل من صورة مصر الذهنية، على نحو أعاق محاولاتها للتطور، بل وقلص قدرتها على التأثير الناعم في محيطها العربي والإسلامي. خاصة أن هذا الإرباك سار بالتزامن مع عمليات أخرى استهدفت تفريغ هذا الوعي من مضامينه ومكوناته وزعزعة ثقته بكينونته، عبر إفقاد الفرد القدرة على إدراك جوهر الحقائق، ودفعه للشك في سلامه معتقداته والريبة في إرثه الاجتماعي، الذي انتقل إليه عبر الأجيال المتعاقبة مكللا بخبرة التجارب مزدانا بحكمة السنين.
حتى بات المصري قلق في كثير من الأحيان على صحة معتقده، منشغل بـمدى «شرعية» ملبسه وصحة ما يلفظه بل ومتشكك في بعض مناسباته الاجتماعية والوطنية. خاصة في ظل النيل المتعمد من مصداقية فتاوى المؤسسة الدينية وأحكامها الشرعية، بل والغمز واللمز في حق قُرّاء القرآن الكريم وهم الذين تفردوا بجمعه ترتيلا وتجويدا، منذ جمعه مخطوطا أول مرة في عهد عثمان بن عفان
2. تتابع الأزمات:
لقد كان للهزات السياسية والأزمات الاقتصادية المتتابعة التي تعرض لها المجتمع المصري دور في دفع الوعي الجمعي إلى دائرة الاعتلال، خاصة في ظل التداعيات التي ترتبت على تفتيت البنية الزراعية، وهجرة أبناء الريف للعيش على أطراف المدن وهوامشها وتلاشي الملامح المميزة للريف عن الحضر، وتراجع قيمة العمل والإنتاج لصالح الاستيراد والتجارة غير المشروعة تحقيقا للكسب السريع. والتي أدت إلى نوع من الانقلاب الاجتماعي الذي تمثلت دلائله في اختلال التوازن الطبقي، واتساع الفروق الطبقية، وانهيار الطبقة الوسطى الحضانة الأساسية لقيم المجتمع وتقاليده المتوارثة، وتدهور المنظومة القيمية. بينما كانت الطبقة الانتهازية تتسع، والفساد والمحسوبية والنفعية تتفشى بالمجتمع. الأمر الذي دفع كثير من أبناء الطبقات المضارة للبحث عن ملاذ يؤمنون به مستقبلهم، حتى تتسنى لهم فرصة الحصول على عقد عمل بالخارج، أو الهجرة.
3. زيف الصحوة:
في ظل هذه الأنساق الاجتماعية الدخيلة والأزمات الاقتصادية، انفردت «الصحوة الإسلامية» بالمجتمع المصري، لتعيد برمجة وعيه الجمعي على نحو يقنع بعض أفراده بسرديات دينية تدعوهم للفرار إلى الله، بعيدا عن تناقضات واقعهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وعلى هذا برزت جماعات تتسمى بمسميات معبرة عن نزوح وعيها عن هذا الواقع، بل ومتربصة بأنساقها الاجتماعية ومعتقداتها الدينية، مثل جماعة «التوقف والتبين» المعروفة إعلاميا بـ«التكفير والهجرة» و«الناجون من النار» و«الجماعة الإسلامية» و«التبليغ والدعوة» و«طلائع الفتح» والتي تسابقت مع الجماعات السلفية الأخرى والإخوان والصوفية في بناء قواعد جماهيرية مؤمنة بأفكارها ومناصرة لها.
ومن ثم انبرى نجوم «الدعوة السلفية» بأرديتهم الخليجية و«الدعاة الجدد» بحللهم الأنيقة لإعطاء العامة جرعة وعي دفعتهم للتقوقع داخل أوهام الماضي، لا يستدعون منه إلا صليل السوف وصهيل الخيول؛ إما لإدارة الصراع مع هذا الواقع غير الراضين عنه، أو استبدال الأنساق الاجتماعية المستقرة والروحية المعتدلة بقيم ومفاهيم أصولية مقترنه بالجزمية. انطلاقا من اعتقادهم أن هذه القيم والمفاهيم هي المعيار القياسي للإسلام الصحيح. بينما ظل الأزاهرة ضمن الجهاز البيروقراطي للدولة غير قادرين على تجديد خطابهم، بل وتحلل بعضهم من زيه الوقور تمثلا بزي «إمام الدعاة» لعلهم يتخلصون من وصمة «شيوخ السلطان» التي طالما دأبت أبواق الصحوة على مطاردتهم بها
غير أن المحصلة النهائية لهذه الصحوة الزائفة تفاقم النفاق الاجتماعي وتحول العامة إلى التزمت الأجوف الذي يتعالى فيه الفرد على مجتمعه بمظهره «الشرعي» دون التخلق بالأمانة والخلق الحسن، ويتباهى بتشدقه بسردية لغوية ليعبر بها عن «التزامه» الذي يحذر فيه من استعمال ألفاظ وعبارات هُيء له أنها «شركية» ويتجنب معه سلوكيات صُور له أنها «بدعية» بدعوى أنها لم تثبت عن النبي.
والأخطر من هذا، أن فهم العامة لتاريخهم وحضارتهم بات منحصرا في المنظور الذي طرحه «وعاظ الصحوة» عندما قدموا تفسيرا قرآنيا لكل شيء، يماثل التفسير التوراتي، كدأب بعضهم إخضاع الفرضيات العلمية لفهمهم للنصوص الدينية بزعم أنه «إعجاز علمي بالقرآن» و«طب نبوي» الأمر الذي أدى في النهاية إلى تكون أجيال لا تؤمن بالعلم ولا تنتمي لحضارتها ولا تنظر لشواهدها إلا على أنها أصنام وأوثان يجب تحطيمها.
ولم تنس «الصحوة» الثقافة والفنون والآداب المصرية من حملتها «الدعوية» فحرّمت الفنون بأنواعها واستدرجت الكثير من الفنانين والفنانات للاعتزال إما بالإغراء المالي تارة، أو بالزواج من حسناوات السينما تارة أخرى. كما قاد دعاتها حملات النيل من المبدعين بدءا من «قاسم أمين» و«طه حسين» و«نجيب محفوظ» وصولا إلى «يوسف إدريس» و«توفيق الحكيم» مبتدعين بديلا يسمى «الادب الاسلامي» الأمر الذي أسهم في إفراغ الساحة الفنية والأدبية من مبدعيها، وتصدر أنصاف الموهوبين الذين تلقفتهم الشركات المتحكمة بسوق الإبداع حرصا على تلبية شروط المشتري بينما سهل الفاسدون السطو على الأرشيف المرئي والمسموع من اتحاد الاذاعة والتليفزيون، كما تربحوا من وراء بيع أصول الأفلام السينمائية وبعض المخطوطات والوثائق والكتب النادرة.
4. الإخفاق الإعلامي:
لقد بدا الخطاب الثقافي والإعلامي فاقد للمصداقية، عاجز عن معالجة التناقضات التي أخذت تسود المجتمع، على نحو جسد عمق الفجوة بين «الجماهير» و«السلطة» حتى ابتكر الوعي الجمعي المصري «التطبيل الإعلامي «تعبيرا عن شعوره بعدم التقائه، بوصفه «المستقبل» مع الإعلام الرسمي «المرسل» في نقطة المصداقية، ورفضه المبالغة التي طالما صاحبت مضمون «الرسالة» التي يطرحها، وعدم استساغته للغة التي يستخدمها. خاصة أنها ظلت تعتمد ذات السرديات القديمة، التي كانت سائدة في أزمنة العنفوان الثوري وإدارة الصراع داخليا وخارجيا، حتى انكشفت سوءاتها بهزيمة يونيو 1967م، على الرغم من أنها أدت دورا محسوبا في رفع معنويات الجماهير وشحن عواطفهم الوطنية وقت التحولات المصيرية، مثلما حدث أثناء انتصارات أكتوبر 1973م، وثورة يونيو 2013م
والحقيقة أن «التطبيل» مجرد وصف لما أصاب الجهاز الإعلامي، وعدم قدرته على تلبية طموح الجماهير والفوز برضاها خاصة بعد ظهور فضائيات عربية تمتلك القدرة على إدارة الرأي العام وقيادة التغيير بالمنطقة. بينما لجأت القنوات المصرية لصحفيين استخدموا أدواتهم الصحفية في إعلام مرئي، واستعانت بمعدين لا صلة لهم بعلوم الإعلام والاتصال، فتسببوا في تسطيح الوعي وتعزيز الضحالة والاستفزاز لدى المتلقين. ومن ثم فشل الإعلام في بناء مفهوم للمواطنة يتعزز معه الوعي بالحقوق والواجبات وتتأكد به أهمية العلم والعمل والانتاج والابداع. ناهيك عن فشله في إرساء قاعدة مشتركة بين الدولة «المرسل» والجماهير «المستقبل» عندما تعمد عدم إيصال صوتها للدولة حول إخفاق جهازها البيروقراطي في تلبية احتياجاتها، أو تحقيق طموحاتها.
ولعلنا ندرك أن التحولات التي شهدها المجتمع المصري ولدت تناقضات بين طموح الجماهير نحو التطور الاقتصادي والثقافي، وبين الواقع الذي لا يستطيع تلبية هذا الطموح. وقد نفهم أن الإعلام كان له الدور الأنجع في الترويج لمشروعات الرئيس عبد الناصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لأن الدولة كانت هي «المرسل» الحصري لكل «الرسائل» الموجهة للجماهير «المستقبل» وقت أن كان المجتمع مستقرا راضيا، طبقاته متماسكة وملامحه الفئوية واضحة بين عمال وفلاحين، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة نسبيا. ومن ثم كان من الطبيعي أن تؤمن هذه الجماهير برسائل عبد الناصر وتتفاخر بإنجازاته، بعد أن نجح في خلق وعي جمعي وقاعدة شعبية مؤمنة بأهمية مشروعاته التنموية، ومقتنعة بأن الهدف من هذه المشروعات هو تحقيق مصالحها الأساسية وتعزيز مكانة مصر الخارجية.
وعلى الرغم من هذا، لابد أن نعترف أن الجهاز الإعلامي يواجه اليوم صعوبة في إيصال رسائل الدولة إلى الجماهير، بعد التغير الذي طرأ على البيئة المتلقية لهذه الرسائل، خاصة أن مساحة عدم الرضا لدى المتلقي أصبحت أوسع مما ينبغي؛ لاعتبارات كثيرة منها أن هذه الجماهير ظلت اشتراكية الهوى والتفكير، على الرغم من أنها تحولت إلى رأسمالية الاستهلاك، التي ولدت لديها تطلعات لا تمتلك القدرة على تحقيقها، وتحمل الدولة مسئولية التقصير تجاهها، وتتهمها بأن ما تنفذه هو فقط لصالح الاغنياء. والأدهى أن الإعلام الحالي يغذي ذلك الشعور الخاطئ بشكل غير مباشر.
وهنا بدا الأمر كأن الإعلام يسهم في هزيمة أهداف التنمية بالمجتمع، لكن الحقيقة التي يتعين علينا الالتفات إليها هي أن العلاقة الوثيقة بين الإعلام التقليدي والتنمية بالدولة قد تفككت، بعد ظهور الإعلام الافتراضي ومنصات التواصل الاجتماعي، الذي بدل أركان الاتصال فجعل «المستقبل» مرسلا و«المرسل» مستقبلا. وبما أن القرن الحالي هو قرن الشعوب التي تعاني معظمها الجهالة والحقد الطبقي وانخفاض مستوى التعليم وعدم حصولها على الخدمات على نحو يرضيها عن الدولة، فمن الطبيعي أن تكون الرسالة التي يتبناها الشعب، بوصفه «المرسل» الجديد، انطباعية وغير صحيحة، بل ومضللة وتولد تغذية راجعة تدفع القواعد الجماهيرية، بتردي مستواها التعليمي والثقافي، نحو الانتهازية والتردي الأخلاقي والفوضى، والانتماء إلى الفكرة أكثر من الإيمان بالقيمة. بحيث تنتمي لفكرة الكسب الحرام مثلا على حساب القيم الأخلاقية.
وبما أن الاعلام التقليدي لم يعد منفردا بمهمة المرسل، لصالح الإعلام الافتراضي الذي هو أكثر حرية وتأثيرا وقدرة على إدارة الوعي عن بعد، لدرجة أنه يمكن أن يصبح وسيلة للحرب النفسية ضد الشعوب وتحطيم معنوياتها من خلال بث مشاعر اليأس والإحباط فيها لدفعها نحو الفوضى وتدمير ذاتها وأوطانها. فعلينا أن ندرك أن مصر باتت في حاجة ملحة لإعادة بناء وعي أبنائها علة نحو يعزز مكامن القوة فيهم، ويخلق رأي عام مدرك لأهمية العلاقة بين التنمية وتحقيق مصلحة كل فرد فيه.
5. التراجع الثقافي:
على الرغم من أن مصر تمتلك مقومات ثقافية خلاقة بلورت جوهر وعي المصري بذاته وجسدت معالم هويته ورسخت لديه شعور دائم بالانتماء لوطنه وعروبته. إلا أن إدرة هذه المقومات أفقدها القدرة على التعبير عن تطلعات الجماهير، كما تركت المصري ضحية لصناعة ثقافية خارجية غيرت كثيرًا في انتماءاته السمعية والبصرية والعقيدية والفكرية، وسدت الأفق الثقافي أمامه وغيبت وعيه عن قضايا مجتمعه الحقيقية، وأربكت ترتيب أولوياته، ووضعته أمام جدليات ضحلة ومُربِكة؛ لأنها غير معنية باستنهاض القيم الداعمة للعلم والعمل وحُسن الخُلق فيه. وبالتالي ظهرت أجيال مصرية لديها شعور عميق بالتقزم، منسلخة عن ذاتها وقيمها، غير مدركة لقيمة مصر الفكرية والثقافية
وفي المقابل، فشلت وزارة الثقافة في استثارة مكامن الإبداع بالمجتمع؛ فتوسعت رقعة الفراغ الثقافي والفني وتراجع دور الثقافة المصرية لصالح بروز أنماط ثقافية إقليمية فبرز منها النمط الخليجي المحافظ، والنمط الإيراني المذهبي والتركي الانتهازي. حتى فقدت مصر عمقها الاستراتيجي الثقافي، خاصة في ظل المحاولات المستمرة لتفكيك مركزيتها الثقافية، بالتزامن مع تراجع الإنتاج السينمائي والمسرحي وتقلص الفنون الشعبية وتحول قصور الثقافة إلى مجرد أداء بيروقراطي مترهل. كما انعدمت الأنشطة الثقافية والفنية داحل المؤسسات التعليمية، التي كانت تكتشف المواهب وتدفع بها نحو عالم الإبداع.
كما لم تدُرك أيضا ضرورة الانتقال لعصر «الثقافة الرقمية» الذي تجاوز بتقنياته حدود المستوى التعليمي للفرد وفئته العمرية ونوعه ولغته وعقيدته وعاداته وتقاليده؛ حتى باتت أكثر عجزا عن أداء مسئولياتها تجاه إعادة بناء وعي جمعي يحقق لمصر نهضة فنية وثقافية شاملة، وحث مكامن الإبداع الفني والخلق الثقافي بالمجتمع على نحو يفعِّل دور الفرد في عمليات التنمية الشاملة بالدولة.
6. الفشل التعليمي:
تعاني المنظومة التعليمية من الفشل المزمن سواء على مستوى التعليم الأساسي أو الجامعي، وذلك لأسباب عدة، منها: نقص الإنفاق العام على التعليم، ونقص المنشآت التعليمية والفصول الدراسية والمعلمين، الذي يزداد طرديا مع الزيادة السكانية. كما تعاني أيضا من تعدد أنماط التعليم ما بين «أزهري» و«فني» و«عام» ويتوزع هذا الأخير لنوعين من المدارس، إما خاضعة لوزارة التربية والتعليم (حكومية وقومية وتجريبية ويابانية) أو مدارس تعليم خاصة (عربى وناشونال وإنترناشونال وراهبات)
وتعاني معظم المدارس الخاضعة للوزارة، والتي يلتحق بها الأغلبية الساحقة من أبناء المجتمع، من انعدام شبه كامل لجودة المخرجات التعليمية؛ نظرا لرداءة تصميم الكتب والمناهج، وتدهور المنشآت والتجهيزات والوسائل التعليمية وضعف مستوى المدرسين وتدني كفاءة الجهاز الإداري. إضافة لعدم قدرتها على سد الفجوة الرقمية والمعرفية بينها وبين نظم التعليم المتقدمة بالدول الأخرى.
كما يعاني المواطنون من مغالاة مدارس التعليم الخاص في مصروفاته. ومن ناحية أخرى تركز هذه المدارس على توفير بيئة تعليمية متعددة الثقافات تستقبل قيم الثقافة الغربية، على نحو يعزز انفصال المتعلم عن واقع مجتمعه وثقافته بدلا من تأهيله للمساهمة في تطوير هذا المجتمع. أما التعليم الجامعي الذي يستقبل الحاصلين على شهادات التعليم الأساسي، فيتنوع بدوره بين جامعات «حكومية» و«أهلية» و«خاصة» إضافة للأكاديميات الحكومية والخاصة المتخصصة وجامعة الأزهر.
وقد فشلت المنظومة التعليمية في ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل، على نحو فرض سياقا اجتماعيا فاقد الأمل في الحصول على تعليم بجودة عالية، ومتخوف من أي محاولة للتطوير خوفا على مستقبل أبنائه خاصة مع كثرة التجارب والمحاولات الفاشلة في السابق.
دعوة لإعادة البناء
لقد بات الوعي الجمعي بمصر في حاجة ملحة لإعادة هندسته وبنائه من جديد، كي تنجلي أمامه الحقائق وتزيد قدرته على التمييز بين الصالح والطالح، ويتجدد فيه الأمل في المستقبل والعزيمة على تغيير الواقع إلى الأفضل؛ وتتحول الجماهير إلى قوة دفع للتنمية بدلا من أن تظل غير مدركة لأبعادها وغير مبالية بأهميتها ضمن الرؤية الشاملة للدولة. وذلك من خلال المقترحات التالية
أولا: التخطيط الاستراتيجي: وضع خطة استراتيجية ذات مديات متعددة لتطوير الأداء الإعلامي والثقافي لمواكبة شتى المتغيرات، وتلبية ضرورات بناء الوعي الجمعي الصحيح. على أن تراعي ما يلي:
هيكلة وزارتي الثقافة والإعلام هيكلة بنيوية تدمج الثقافة «الرسالة» بالإعلام «الوسيلة» بوصفهما ركائز مهمة لبناء الوعي الجمعي وتعزيز المواطنة الصالحة والانتماء
وضع العمل الثقافي والإعلامي في موضع قيادة الإبداع وتعزيز الابتكار بالمجتمع وتنمية مهاراته التي تعوزها التنمية. مع الحرص على نشر الإيجابية والبهجة لتعديل المزاج العام والارتقاء بذوقه
ربط الجهاز الإعلامي بالتقنيات والوسائط المختلفة؛ لإنتاج مواد إعلامية ذات محتوى علمي يحقق أهداف التنمية ويرفع مستوى الوعي الجمعي.
إفساح المجال أمام التعاون بين وسائل الإعلام التقليدي والإعلام الالكتروني في إنتاج محتويات ثقافية وتعليمية وترفيهية ورياضية…إلخ وبناء محتوى علمي مدعوم بالتقنيات المتقدمة. على أن يتميز بمستوى عال من جودة المحتوى والإبهار البصري.
إنشاء منظومة إعلامية وثقافية متكاملة، موجهة للأطفال والشباب اليافعين
ثانيا: إنشاء منظومة اتصالات متكاملة لإدارة جميع المنصات وضبط محتوياتها وفق استراتيجية الدولة، وتخصيص جوائز ومحفزات مادية ومعنوية لتشجيع أصحاب الابتكار العلمي والمحتوى القيمي الأكثر تأثيرا في الرأي العام. وإنشاء آلية مراقبة وتتبع للتخلص من المحتويات السلبية وطرح مبادرات للتطوير المستمر للمحتويات. مع مراعاة نشر المحتويات الهادفة، ولاسيما التي تركز على:
– حقائق تاريخ مصر والمنطقة العربية بشكل موضوعي؛ لتعزيز الفهم الصحيح بالتاريخ وعرض الأماكن والمزارات التاريخية المختلفة بوصفها مرآة للتعلم واستخلاص القيم والدروس التاريخية.
– إبراز القيم الروحية والثقافة والاجتماعية والتاريخية وأهيمة تناقلها بين الأجيال لخلق فهم عميق لديها بأهمية الارتباط بالوطن والانتماء إلى ذاته والافتخار بها بين الأمم.
– تحسين التفاعلات الاجتماعية عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي
ثالثا: إنشاء مراكز للدراسات والبحوث العلمية، لنشر المعارف العلمية ودفع روح الإبداع والابتكار إلى الأمام، وتطوير المشروعات الثقافية بالدولة. على تأخذ في اعتبارها ما يلي:
– إجراء دراسات حول تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية على منظومة القيم.
– التحليل الموضوعي الشامل للأوضاع الداخلية والخارجية لعرضها على الرأي العام بشفافية
– زيادة الوعي بخطورة الزيادة السكانية على التنمية من حيث زيادة الضغوط على فرص العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي والتعليم والرعاية الصحية والموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية التي تعد أساسا للتنمية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة بالمجتمع بشكل عام.